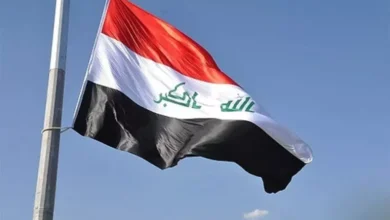لص في الذاكرة!

بقلم: حسين الذكر
كلما تأملت قول أبي ذر الغفاري، ذلك الراهب النقي السمو، الذي يشبه تماس الصحراء بنقطة التقاء السماء بأجمل وأبهى صورها، وهو يقول: “عجبت لرجل لا يجد قوت عياله ولا يخرج حاملاً سيفه”، شعرت بعذوبة الدعوة الصريحة التي تحرم احتكار الأرزاق، وتقدم فتوى ناصعة تُنسّي الإنسان قيود الجوع بأسنّة الحراب إذا اقتضت الضرورة.
لا زلت أذكر تلك القصة التي رواها لنا معلمو الصف الأول الابتدائي، حيث كانوا يغرسون في أذهاننا النصائح بأسلوب اجتماعي وأدبي محبب. تقول الحكاية: وجد طفل بيضة دجاجة وأتى بها إلى أمه، التي فرحت بها دون أن تسأله عن مصدرها. وفي اليوم التالي، بحث الطفل عن بيضة أخرى فلم يجدها، فاضطر لسرقة بيضة من قن دجاج الجيران. ومن هنا بدأت “العلة الأولى” في الرغبة بالحصول على الرزق بأسهل الطرق.
ومع مرور الزمن، تصاعدت وتيرة الجرأة والشجاعة لدى الطفل، حتى وصل الأمر إلى الاعتداد بالنفس مع تعدد ضحايا الدجاج والديوك والكلاب والأغنام، حيث كان يتفنن في سرقتها. ومع تراكم التجارب، جمع حوله مجموعة من المشردين والمتسربين من المدرسة، وتطورت القضية من مجرد رغبات إلى جرائم انتهت بالحكم عليه بالإعدام. وعندما طلب المدان رؤية أمه لوداعها، عض لسانها بقوة قائلاً: “هي من شجعتني وعلمتني على السرقة”.
قد تبدو الحكاية طفولية وطريفة، تصلح للأطفال في سياق تربوي وإرشادي، إلا أنها في الواقع لا تعد سببًا وحيدًا لصناعة المجرمين، لا سيما أصحاب الكبائر، التي قد تبدو صغيرة مقارنة بما يرتكب من جرائم باسم التشريع.
يقال إن أرسطو كان أول من ميّز بين السرقة كفعل شائن، وبين بعض أشكال الاستحواذ التي قد تكون مبررة في حالات الضرورة القصوى، وهو تفريق فلسفي بين الجريمة والدافع.
السرقة تعرف لغويًا واصطلاحيًا بأنها: “أخذ الشيء من الغير خفية”، ومنها الاسترقاق السمعي، أي سماع شيء مستخفياً، ويقال أيضًا “سرقة النظر” إذا انتظر الشخص غفلة لينظر إلى شيء لا يخصه. هذه التعاريف لا تنحصر عند حدها الأول، بل تتنوع بين اللغة، والاصطلاح، والفقه، والقانون، والعرف، مما قد يؤدي أحيانًا إلى تضارب في فهم المفاهيم حسب الزمان والمكان، أو حسب ميل السلطة وحب الذات، إلى جانب ألوان التعريف الأخرى التي قد تنسف التعريف الأول.
شخصيًا، تعلمت شعبيًا ومن خلال البيئة التي نشأت فيها أن السرقة هي: “كل محاولة للاستحواذ على ممتلكات الغير، مادية أو معنوية، دون علم صاحبها وبموافقته، ويستحق مرتكبها لقب ‘لص'”. هكذا ترسخ المفهوم في ذهني منذ الطفولة، حتى أصبح لدي خوف طبيعي من التعامل مع ممتلكات الآخرين، حتى وإن رغبت نفسي بما لديهم.
أتذكر موقفًا كنت فيه مع والدي رحمه الله في أحد الأسواق، حين حدثت جلبة كبيرة بسبب رجل شرس ذو صوت أجش وعضلات مفتولة، هدد امرأة شبه عارية أمام جمع من الناس، مطالبًا إياها بتسليم محفظة امرأة أخرى. المشهد كان دراميًا، حيث صرخت المرأة وألقت المحفظة التي تحتوي مبلغًا زهيدًا، وحاول بعض الحاضرين التدخل لردع المعتدي وحماية الضحية، فيما تدخل بعض الصالحين لاسترجاع المحفظة وتعويض المرأة عن الفضيحة.
هذه الأحداث تعكس فلسفة اللصوصية والسرقات في التاريخ، حيث تمثل محنة دينية وفلسفة وجودية، تبحث عن أسباب تحايل الفقراء لضمان العيش، ولو بطرق غير مشروعة، في حين تسكت المجتمعات عن أكبر سرقات الحكومات، التي قد تصل بالمليارات دون مساءلة. كثير من رجالات الحكم، في مختلف الأزمان، فروا من الرقابة والحساب، وتركوا خلفهم إرثًا يُعد حرامًا من منظور الدين، فيما يواصلون التمتع بالمحللات والمسكرات وغيرها من المحرمات.
من أجمل ما قيل عن السرقة: “السرقة ليست في اليد، بل في الضمير”. هذه المقولة تحمل فلسفة تربوية مهمة، تؤكد على إصلاح الضمير المجتمعي وحماية الفئات الضعيفة من الفقر والعوز، حتى لا تتحول ضحية للمخاطر.
ورحم الله جان جاك روسو حين قال: “الوطن هو المكان الذي لا يبلغ فيه مواطن من الثراء ما يجعله قادرًا على شراء مواطن آخر، ولا يبلغ فيه مواطن من الفقر ما يجعله مضطرًا أن يبيع نفسه أو كرامته”.