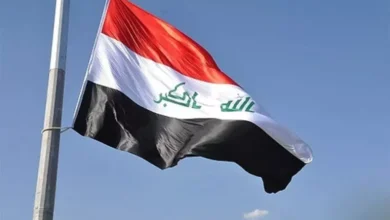تجفيف اللغة

بقلم : د. صالح الفهدي
في أحد المجالسِ التي تُعرضُ فيها مواضيعَ مُختلفة للنِّقاش ، كان اللقاء بأحدِ المشرفين على مشروع خيري ، وكانَ عُمانيَّاً لكنَّ النسبةَ الغالبةَ من حديثهِ رَطَنها بالإنجليزيَّة ، دون مُبرِّر؛ فلا الموضوعُ يتطلَّبُ منهُ أن يستخدمَ مفردات ومصطلحات أجنبية ، ولا الحضورُ كانوا عجماً لا يفهمون العربية! فما الذي دفعهُ لأَن يرطُنَ بغيرِ لغتهِ ، أمام أهل لغته؟!
لقد بدا هذا الرجلُ نموذجاً لفئةٍ تتوسَّع في استخداماتها للمفردات الأجنبية ، وليس ذلك لقصورٍ في العربيةِ ، وإنَّما لنكوصِ أهلها عنها ، فما الذي يدفعُ من يفضِّل أن يقول “أولْرِديalready ” بدلاً من أن يقول “مُسبقاً”، وقد سمعتُ الكثير ممن يستخدمها بالقول : أنا “أولْردي” عملتُ كذا ، أو أعطيته خبر “أولْردي” ، أيكونُ عذرهُ بأنَّه لا يعرف المفردة العربية البديلة “مُسبقاً” ليقول : أعطيته خبرا مسبقا؟! فإنني لا أعتقدُ ذلك فهو في الحقيقة يستحسن استخدام المفردة الأجنبية ، ويفضِّلها على العربية ، لغتهُ الأم ، لغة آبائه وأجداده ، لغة هُويته ، وذاته.
في المُقابل تشهَدُ اللهجة الدارجة تجفيفاً لروافدها ، حتى أنَّ الناس في مجتمعنا لا يكادون يجدون عبارة حتى يتمسَّكوا بها من مِثْل “الأُمور طيِّبة” فتجدها شائعة ، لأنهم لا يكادون يجدون بديلاً عنها ، وكأنما جفَّت روافد العربية! ، وعبارة أُخرى تُقال في المناسبات وهي “كُلُ عام وأنتم بخير” وكأنها نصٌّ مقدَّس لا يجوز تغييره ، يتداولها المجتمع في رسائله وتواصله ، وكأنها لا بديلَ عنها ، واستعرضْ -أيُّها القارئ- كلمات المناسبات من أفراحٍ وأتراحٍ تجدها هي نفسها لا تتغيَّر ، ولا تتبدَّل ، وذلك ما يعبِّر عن جفاف اللهجةِ الدارجة ، وقصور أهل اللغة العربية عن الاجتهاد والابتداع في الإتيان بالبدائل التي تروقُ للسَّمع ، صياغةً وتجديداً.
أما بعض مظاهر تجفيف اللهجة الدارجة فمنها اختفاء الأمثال الشعبية التي كانت ضمن سياق التواصل اللغوي بين النَّاس ، فيدلِّل القائل بالمثل الشعبي أو العربي في قوله ، وهو ما يعني تعميق التصوير للفكرة التي يريدُ إيصالها ، وأذكر أنني كتبتُ مسرحيَّةً ضمَّنتها (70) مثلاً شعبياً ، وكتبتُ بحثاً عن “الشخصية العُمانية في الأمثال الشعبية” استخلصتُ منه صورة العُماني من أَلفي مثل ، الأمر الذي يعني أنَّ المثل الشعبي متعمِّقٌ في السياق اللغوي المجتمعي للإنسان العُماني.
اختفت القصَّة الشعبية التي كانت تُروى من قِبل الأُمهات والجدَّات ، حيث أذكرُ أننا إخوةً وأخوات في طفولتنا كُنَّا نتحلَّقُ مساءً حول أُمَّنا وهي تقصُّ القصَّة علينا ، فتغطُّ عينها قليلاً ، فنسرعُ في إيقاظها وحثَّها على مواصلة القصَّة لفرطِ حماسنا لمُتابعةِ القصَّة ، واختفت الملاحم الشعبية كملحمة الأمير أبوزيد الهلالي ، وملحمة الملك الحِميري سيف بن ذي يزن ، الذي أذكر أنَّ والدي كان يقصُّها علينا على مدار ثلاثة مساءات.
أمدَّتنا هذه القصص والملاحم بالمُفردات والصُّور وألهبتْ أخيلتنا ، وسافرت بنا إلى أقاصي الأرض ، وعرَّجت بها إلى تمثُّل سِمات الشخصيات وتصوُّر الأحداث ، مما أسهم في إثراءِ قواميسنا اللغوي التي تختزنها الذاكرة ، فتجودُ بها على مختلف تعابير المُناسبات بكلِّ يُسرٍ وسلاسة.
اختفتْ مدارس القرآن الكريم أو الكتاتيب التي تزوِّدُ الطفل في بواكير عُمره بالمعاني الروحية ، وآلاف المفردات العربية فيشبُّ وقد ترسَّختْ المعاني والمفردات في نفسه.
ها نحنُ إذن بين تجفيف مُتزايدٍ للعامية ، وعزوفٍ مُتقادمٍ عن استخدام الفصحى وكأننا قد ارتضينا بهذا المسار ، حتى ضاقت بنا السُّبل ، وها أنتَ ترى حين تحيِّ -بعبارةٍ مختلفة عن العبارات المتكررة- شابَّاَ فإنَّهُ يُصدَمُ ، فيتوقفُ عقلهُ فيما سيردُّ به عليك ، فيشعرُ بالحَرج! ذلك لأنَّه يفتقدُ للثراء اللغوي الذي لا يمدُّه بالمفردةِ وحسب بل والقدرة الفورية على صياغة العبارة المُناسبة في صورة سليمة، مُتناسقة ، ومتوافقة.
وإذا كان هذا حالنا ، فإِنَّ شعوباً أُخرى ليست عربية اللِّسان قد بدأت تتفوَّقُ علينا في تحدِّثها باللغة العربية حتى جعلتنا في منزلةٍ أدنى منها حين نحادثها لأنها اعتادت على اللغة العربية ، بينما أضعفْنا نحن -أبناؤها- الاتصال بها ، فجازتنا بالجفاءِ إزاء عقوقنا ، وجازتهم بالقربى إزاءَ برِّهم بها! على سبيل المثال: أحد الأطباء الشباب من أوغندا كان يتحدَّث بلغةٍ عربيَّةٍ فصيحةٍ عن هرمونٍ يُفرَزه الجسم ، فطلبتُ منه توضيحاً مفصَّلاً ، فأرسل لي رسائل صوتيَّةً بعربيَّةٍ فصيحة لم يستعن فيها بمفردةٍ أجنبيَّةٍ واحدةٍ ، على خِلافِ ما قد يكون من طبيب عربيِّ اللسان -إلا القلّة- إذ سيحشر كلامه بألفاظٍ دخيلة!. وأيضاً حوَّل لي أحد الإخوة رسائل نصيَّة من أحد الدبلوماسيين السنغاليين وهو يُثني بلغةٍ عربيةٍ فصيحةٍ على أحد أعمالي ، ويُبدي اهتمامه بمعرفة المزيد عن تاريخ وحضارة سلطنة عُمان.
هكذا نُسهم في مأزقنا المُتمثِّل في اضمحلال العاميَّة من ناحية ، وضعف التواصل باللغةِ العربية التي اقتصرت على الكتابة عندنا ، وبذلك فإِننا نرتكبُ أبشعَ إثمٍ في حقِّ لساننا العربي ، وفي حقِّ هويتنا العربية ، دون أن نتصوَّر أَثر العاقبة الوبيلة على هُويتنا وذاتنا ، وأختُم هنا بمقولةٍ رائعة للفيلسوف الألماني مارتن هايدغر (ت 1976م) يعبِّر فيها عن تمسُّكهِ بلغته قائلاً : “إنَّ لغتي هي مسكني ، وهي موطني ومستقري ، وهي حدود عالمي الحميم ومعالمه وتضاريسه ، ومن نوافذها ومن خلال عيونها أنظر إلى بقية أرجاء الكون الواسع”.